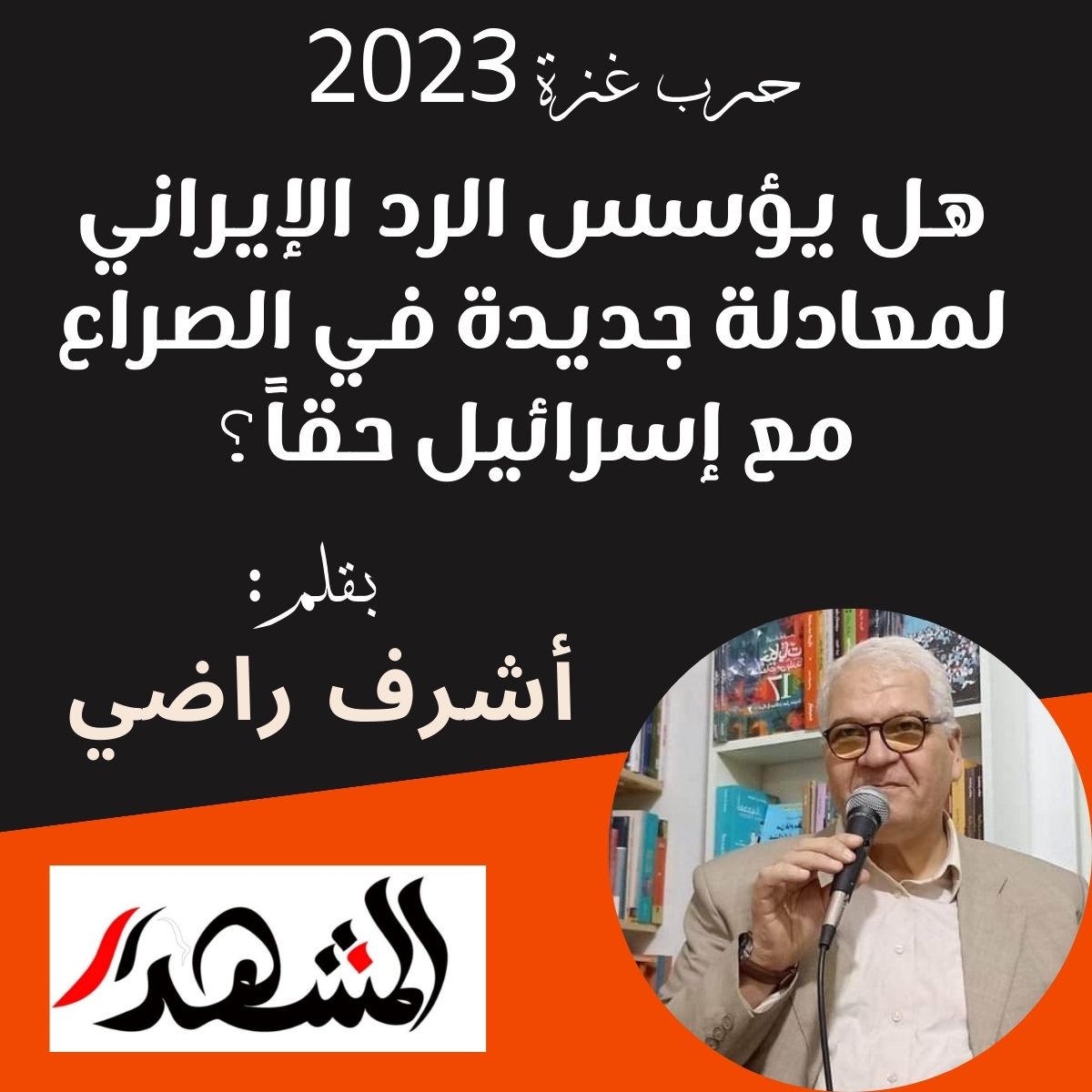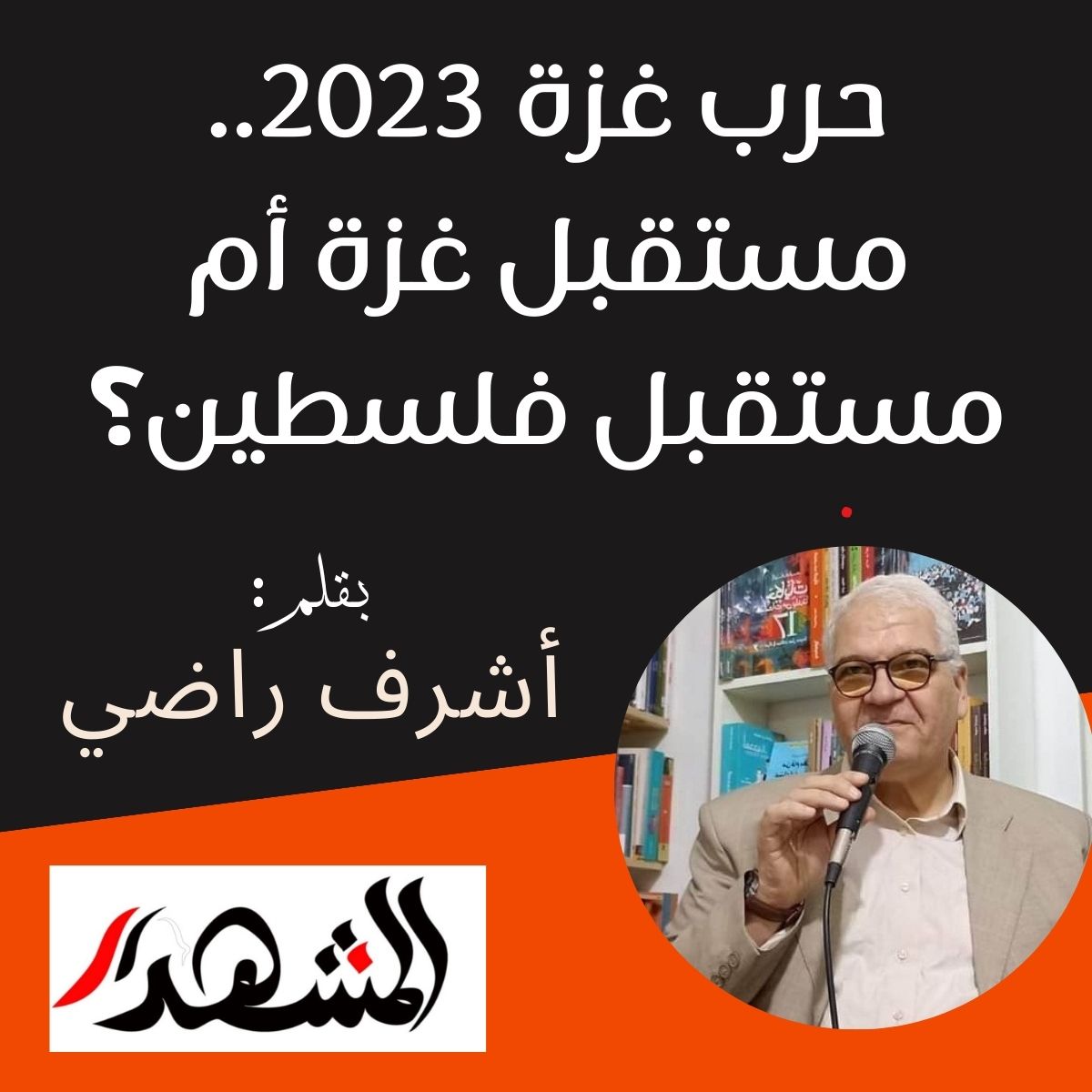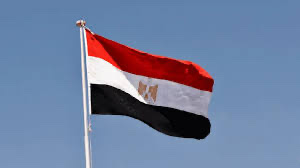اجتاز الصراع الدائر على خلفية الحرب المستمرة في غزة، اختبارا صعباً فجر الأحد الماضي، بعد أن أطلقت طهران نحو 185 طائرة مسيرة وأكثر من 110 صواريخ باليستية و36 صاروخ كروز، لاستهداف مواقع في إسرائيل، في هجوم وصف بأنه أول مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران وإسرائيل، حرصت إيران على تأكيد أنه رد محسوب على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل، والذي جاء في سياق هجمات متكررة منسوبة لإسرائيل تستهدف أصولا عسكرية إيرانية في سوريا. وردت إسرائيل على هذا الهجوم، بشكل مباشر، بشن هجمات جوية على مواقع في لبنان وفي سوريا، وأكدت حقها في الرد على الهجوم الإيراني، في التوقيت المناسب وبالكيفية التي تراها، فيما تمارس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ضغوطاً على حكومة إسرائيل لعدم التصعيد للحيلولة دون الانزلاق لمواجهة إقليمية أوسع، إلى جانب تقديم محفزات لإسرائيل من خلال الدور المباشر الذي لعبته في التصدي الناجح للهجوم الإيراني في أجواء العراق والأردن، بمشاركة قوى دولية وإقليمية حليفة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 80 مسيرة استهدفت إسرائيل قبل وصولها إلى المجال الجوي الإسرائيلي، كذلك حثت الإدارة الأمريكية حكومة إسرائيل على التركيز على المعركة في غزة وعلى الهدف الرئيسي المتعلق بتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبينما اتجهت آراء معظم المحللين العسكريين إلى أن الرد الإيراني المحسوب يؤسس لمعادلة جديدة في الصراع ولقواعد جديدة للاشتباك بين إسرائيل وبين إيران التي تقود محور المقاومة في المنطقة، إلا أن استهداف إسرائيل لمواقع في لبنان وسوريا، لا يشير إلى أي تحول في نمط المواجهات بين البلدين في المدى القريب، ومن غير المتوقع أن يكون للهجوم تأثير كبير على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث بيان لها، صباح الاثنين، بأن 43 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 62 آخرون، جراء غارات شنتها إسرائيل بالطائرات والسفن الحربية والمدفعية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للهجوم الإيراني، فيما تسعى حكومة نتنياهو للاستفادة من تجدد الدعم الدولي، الذي كان قد بدأ في التآكل، لتحقيق مكاسب في غزة والعمل على تكثيف الهجوم على رفح ودير البلح. ومن المرجح ايضاً، أن تواصل إيران استهداف السفن المملوكة لإسرائيليين في الخليج وفي بحر العرب ومضيق هرمز، كما تشير مشاركة حزب الله في جنوب لبنان والحوثيين في اليمن في الهجوم إلى استمرار اعتماد إيران على أذرعها الإقليمية، الأمر الذي يحد من الآمال التي احياها الهجوم بخصوص إمكانية وحدة الساحات وفتح جبهات جديدة للقتال مع إسرائيل، رغم تقارير عن بدء حراك لفصائل المقاومة في الضفة الغربية، وتسليح إيران لهذه الفصائل وتزويدها بقدرات قتالية استعداداُ لفتح جبهة جديدة في الحرب ضد إسرائيل، إلا أن هذه الأمور جميعا تشير إلى أن الخصمين اللدودين سيواصلان حربا بالوكالة وتجنب أي مواجهة مباشرة قد تفتح الباب لحرب إقليمية أوسع لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصله في ظل البيئة الدولية والإقليمية المعقدة.
غير أن الرد الإيراني المحسوب يكشف عن نمط مغاير لإدارة الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة، حليفها الرئيسي، قائم على فكرة المجازفات الاستراتيجية المحسوبة، الأمر الذي يكشف بدوره عن جوانب للقصور في الاستراتيجية التي تتبعها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والفصائل المتحالفة معها والتي تميل إلى الدخول في مجازفات غير محسوبة، حسب كثير من التقييمات الصادرة عن جهات داعمة لحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى. كذلك كشفت الإدارة الأمريكية للأزمة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي تم دون إبلاغ الإدارة الأمريكية وبدون التنسيق مع واشنطن، عن استمرار امتلاك الولايات المتحدة لزمام المبادرة ونجاح سياساتها منذ هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، في العمل على منع توسع الحرب في غزة إلى حرب إقليمية وضمان ألا تحدث التداعيات المرتبطة بالحرب تحولات جذرية في موازين القوى الدولية يحد من قدرتها على إدارة الصراع، بل ونجاحها في ضبط إيقاع ردود الفعل الدولية والإقليمية بما يتماشى مع أهداف السياسة الأمريكية.
وتشير التطورات على المستويين الإقليمي والدولي إلى طبيعة القيود المفروضة على الأطراف الرئيسية المتصارعة أو المتنافسة في المنطقة، كما تكشف عن هيكل الفرص المتاحة لتغيير نمط الصراع الراهن إذا نجحت الأطراف الرئيسية في توظيفها وحسن استغلالها. والأهم، أن هذا الرد الإيراني وردود الفعل عليه أكدا افتقار الأطراف العربية لأي قدرة للمبادرة للتأثير على الأوضاع لصالح الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الأخرى في سياق السياسات الضاغطة على النظام الإقليمي العربي، والذي يتجلى في عجز الدول العربية، منفردة ومجتمعة،عن الاستجابة لتحديات التنافس على صياغة نظام الإقليمي القائم بين إسرائيل وتركيا وإيران، وما يعنيه ذلك العجز من فقدان السيطرة على المقدرات والموارد العربية وإضعاف الدول العربية والتأثير على خططها وبرامجها التنموية، وإخراجها من دائرة التنافس على رسم ملامح النظام الإقليمي الناشيء الذي تتنافس عليه القوى الثلاث التي تقع خارج النظام العربي، بطموحها الإقليمي. قد يكون من المهم محاولة فهم السلوك الإيراني وموقفها من الصراع مع إسرائيل وعلاقة ذلك بالصراع على مستقبل وهوية النظام الإقليمي الناشيء.
طهران تخرج من الظل
يُنسب إلى آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران في أعقاب ثورة عام 1979، التي أطاحت بحكم الشاه، قوله بأن الوقت قد حان كي يجرب العالم الإسلامي الخلافة الفارسية، بعقيدتها الشيعية المهدوية، بعد أن جرب الخلافة العربية، الأموية والعباسية، وجرب الخلافة التركية العثمانية. ومن اللافت للنظر أن المفكر الاستراتيجي الأمريكي هنري كيسنجر في كتابه "النظام العالمي"، الصادر في عام 2013، تعامل مع التهديد الذي تشكله الأصولية الإسلامية الشيعية التي يجسدها حكم رجال الدين في إيران باعتباره التهديد الأساسي في منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن هذه الأصولية أشد خطراً من الأصولية السنية بسبب تناقضها الجذري مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية وأنها قد تكون مصدراً لزعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي. والحقيقة أن كيسنجر واقع، هنا، تحت تأثير خلاف جذري في التفكير الاستراتيجي الأمريكي بخصوص إيران وثورتها الإسلامية، مع النهج الذي تبناه منافسه الرئيسي في صياغة التوجه الاستراتيجي الأمريكي، زبيجنيو بريجنسكي، الذي دافع عن تمكين رجال الدين من السلطة في إيران على أساس أن ذلك سيشكل عامل ضغط رئيسياً على الاتحاد السوفيتي، واحتوائه من خلال تعزيز نظم حكم إسلامية إلى الجنوب منه، ويهدد بامتداد النظم الإسلامية للجمهوريات السوفيتية الست التي تسكنها أغلبية إسلامية، وهو التوجه الذي ساد، رغم معارضة كيسنجر،والذي كان له تأثيرات بعيدة المدى بدأت بالغزو السوفيتي لأفغانستان وما ترتب عليه من تداعيات وتحولات، كما كان لهذا الانقسام تأثير واضح على طبيعة العلاقة المعقدة والمركبة بين الولايات المتحدة وإيران، منذ اللحظات الأولى في عمر الجمهورية الإسلامية.
ولا تخلو ملابسات الثورة في إيران والإطاحة بالشاه، الذي كان يعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط، أيضاً، من دلالات فيما يخص ارتباك السياسة الأمريكية في المنطقة وهو ارتباك ناجم أساساً عن سعي الولايات المتحدة لتحقيق أهداف متعارضة بل شديدة التناقض في الشرق الأوسط. ففي حين أن النظام الجديد في طهران انتقل إلى دائرة العداء المباشر لواشنطن وسياساتها وحلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل، وتبنيه سياسة معلنة تسعى للقضاء على إسرائيل، التي ترى في مشروعها تهديداً لطموحاتها الإقليمية في السيطرة على المنطقة، وسعيه لزيادة حضوره الإقليمي من خلال تبني سياسات داعمة للمقاومة الفلسطينية ولجماعة حزب الله في جنوب لبنان، ولفصائل سياسية عراقية. إلا أنه بالرغم من الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على إسرائيل وعلى السياسات الأمريكية، كانت هناك تقاطعات في المصالح وفي المواقف، دفعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مساعدة إيران في حربها مع العراق وتزويدها بقطع غيار للسلاح الأمريكي ودعمها عسكرياً من أجل ضمان استمرار الحرب بين أقوى دولتين في الخليج وإنهاك واستنزاف قدرتهما العسكرية لحماية مصالح حلفاء واشنطن في الخليج وحماية أمن إسرائيل، ليكون في الوقت ذاته، بمثابة آلية بديلة للتعامل مع الفراغ الأمني والاستراتيجي الذي أحدثه سقوط نظام الشاه. وأتاح تغير النظام في إيران وما يشكله من تهديد لدول الخليج العربية السنية المحافظة فرصة لإعادة رسم السياسة الأمريكية في المنطقة والسعي إلى بناء تحالفات في مواجهة التهديدات الجديدة الناشئة، على نحو يقلل من حدة المعارضة للسياسة الأمريكية الساعية لدمج إسرائيل في المنطقة عبر اتفاقيات للسلام مع الدول الرئيسية.
كان إقدام النظام الجديد في طهران على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وسحب الاعتراف بها والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وفتح سفارة لها في طهران وتقديم الدعم لفصائل المقاومة الفلسطينية، إعلاناً للتحول في الموقف الإيراني، لكنه لم يكن حاسماً، إذ تأثر إلى حد كبير بالموقف من الحرب مع العراق التي اندلعت في عام 1980 واستمرت ثماني سنوات، كما تأثر بعدم وجود قوى حليفة وموالية لإيران نظراً لتهميش الشيعة في كل من كل من العراق ولبنان وسوريا ودول الخليج من ناحية أخرى. غير أن نجاح رجال الدين الشيعة في إحكام سيطرتهم على السلطة في طهران، وإعلان قيام الجمهورية الإسلامية، أعطى دفعة للحركات الإسلامية في المنطقة، على الرغم من اختلاف الأساس الأيديولوجي والعقائدي بين الشيعة والسنة، فانتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت فكرة ملهمة لكثير من هذه الجماعات وكان لها تأثير كبير على أساليب عملها والتركيز على الجانب الحركي والتنظيمي وتنحية الجانب العقائدي جانباً. وأدى انخراط الفصائل الإسلامية الجهادية في الحرب ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان إلى تقليل حدة التناقض بين السنة والشيعة في مواجهة الخطر المشترك الذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي، وساهم الدعم الأمريكي للمجاهدين الأفغان في مواجهة الجيش السوفيتي في تقليص حدة العداء الإيراني للولايات المتحدة، كما كشفت واقعة احتجاز أعضاء السفارة الأمريكية في طهران كرهائن، مدى التشابك بين مصالح القادة الجدد في طهران ومصالح دوائر في السلطة الأمريكية، خصوصاُ أنه لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد فوز الجمهوري رونالد ريجان في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1980، مع ورود تقارير عن الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، الذي كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ذلك الوقت في إدارة أزمة الرهائن ودوره في فضيحة إيران- كونترا، ببعدها الإسرائيلي.
علاقة معقدة مع واشنطن
لا يمكن فهم الإدارة الأمريكية للأزمة الراهنة التي نجمت عن الهجوم الإسرائيلي بمعزل عن السياق العام للعلاقة المعقدة بين واشنطن وطهران، رغم حالة العداء الشديد بين الدولتين. فطهران تصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، المتزعم لقوى الاستكبار العالمي، وتشرف حكومتها على مظاهرات سنوية ترفع فيها شعارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، فيما ترى واشنطن إيران دولة راعية للإرهاب وواحدة من القوى الرئيسية في محور الشر، وترى أنها أكبر عقبة في سبيل إحكام سيطرتها على منطقة الخليج والشرق الأوسط، لكنها تتعامل في الوقت ذاته، تحرص على تغيير النظام الإيراني من الداخل أو استمالته، وإضعافه من خلال فرض حصار عليه، لكن ليس إلى الحد الذي يضعف من سيطرته الداخلية أو من نفوذه الإقليمي، لاسيما في منطقة الخليج. من الصعب تفسير السلوك الأمريكي تجاه النظام الإيراني، بعيداً عن رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على توازن للقوى الإقليمية يحول دون خضوع المنطقة لنفوذ قوة إقليمية واحدة، حتى لو كانت إسرائيل، الأمر الذي ترى أنه قد يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة الحيوية في المنطقة، ويؤثر على استراتيجيتها القائمة على مبدأ إدارة الصراع، والتي تعني حرص واشنطن على استمرار الصراعات في المنطقة والاستفادة من التناقضات والانقسامات بين القوى الإقليمية في سياق استراتيجيتها لإدارة الصراع العالمي وإحكام سيطرتها كقوة عظمى على الصعيد العالمي.
في المقابل، تسعى إيران للاستفادة من الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة، وكذلك من تعارض المصالح بين الولايات المتحدة وخصومها، لاسيما الصين وروسيا، وأيضا من تعارض مصالح واشنطن مع حلفائها الإقليميين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من خلال تطوير استراتيجية لإدارة الصراع والتنافس مع الولايات المتحدة. وحققت السياسة الإيرانية قدراً كبيراً من النجاح واستطاعت تحويل كثير من التحديات والأزمات إلى فرص لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، على النحو الذي يتضح من إدارتها لملف برنامجها النووي والصاروخي. ويمثل النموذج الإيراني تحدياً أساسياً للدول العربية من خلال اعتمادها سياسة للتنمية قائمة على الاعتماد على الذات وبناء قدراتها العسكرية والاقتصادية المحلية. ويذكر أن أحد الأسباب الأساسية التي دفعت الخميني إلى قبول وقف إطلاق النار وانهاء الحرب مع العراق في عام 1988، وهو القرار الذي كان يصفه دائما بأنه أصعب من "تجرع السم"، هو عدم اضطرار إيران إلى الاستدانة من الخارج لتمويل الحرب.
كذلك، لعب الموقف من إيران، خصوصاً بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست في عام 2015، دوراً رئيسياً في تغيير قواعد اللعبة وإعادة بناء التحالفات الإقليمية على نحو يخدم بناء تحالف بين إسرائيل ودول الخليج العربية رغم استمرار القضية الفلسطينية، وتوظيف الخطر الإيراني على دول الخليج العربية على نحو يدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها بالتركيز على الخطر الشيعي الذي تمثله إيران والتقليل من شأن التهديد الذي تشكله إسرائيل لمصالح الدول العربية. وكانت الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في عام 2006، مقدمة لهذا التحول الذي اكتسب قوة دفع كبيرة في أعقاب حرب العراق عام 2003 وصعود نفوذ الأحزاب الشيعية الموالية لإيران في السياسة العراقية، والذي أعطى دفعة لتوسع النفوذ الإيراني في المشرق العربي خصوصا بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومن خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا وتعزيز نفوذ ومكانة حزب الله في السياسة اللبنانية، وتوثيق العلاقات مع جماعة الحوثيين في اليمن وتوسيع النفوذ الإيراني في شمال أفريقيا وفي دول الساحل الأفريقي.
لقد كانت حرب غزة والخلاف حول تقييم الدور الإيراني في هذه الحرب وفي التخطيط لعملية طوفان الأقصى بسبب العلاقة الاستراتيجية التي تربط إيران كداعم رئيسي لفصائل المقاومة الفلسطينية، والعمل على تنسيق المواقف بين الفصائل الإسلامية والشيعية التي تعمل من خلال ما يعرف باسم محور المقاومة، كاشفة لطبيعة العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما مع حرص الدولتين على تجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى حرب مفتوحة بينهما، رغم تقديرات المحللين الاستراتيجيين للفارق الهائل في القوة العسكرية بين الطرفين، وعلى الرغم من نجاح الولايات المتحدة في بناء تحالف إقليمي واسع في مواجهة التهديد الإيراني، والتوقعات المتزايدة والقائمة منذ فترة طويلة عن احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وبين إيران، من جهة أخرى. لكن هذه الحرب محكومة على ما يبدو بحسابات معقدة لارتباطها بجبهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وفي آسيا، وهي الحسابات التي تدفع الولايات المتحدة إلى التركيز، بدرجة أكبر، على اتباع سياسات ترمي إلى تغيير النظام السياسي في إيران كبديل للحرب المباشرة، التي قد تخرج عن حدود المنطقة وعن حدود السيطرة. وتتجلي هذه السياسات من خلال حرص الولايات المتحدة على خفض أي تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما يؤكده الموقف الأمريكي الراهن الضاغط على الحكومة الإسرائيلية لتجنب أي رد قد يؤدي إلى التصعيد مع إيران.
بناء تحالف أم بناء شبكة للأمان
لقد انخرطت الولايات المتحدة في دبلوماسية سرية مع إيران عبر وسطاء للحيلولة دون وصول الرد الإيراني إلى حد يستفز إسرائيل ويؤدي لتصعيد حدة المواجهة، من خلال ضمان ألا يؤدي الرد الإيراني إلى خسائر قد لا تتحملها إسرائيل، وحرصت على إظهار القدرات العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي ومنظومات الدفاع الصاروخي بالتعاون مع دول حليفة وصديقة في الشرق الأوسط، الأمر الذي حال دون وصول معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمتها إيران إلى المجال الجوي لإسرائيل واستهدافها في المجال الجوي لدول أخرى، ونتيجة لذلك لم يحقق الهجوم الإيراني أي نجاح يذكر ولم يصل سوى عدد قليل من الصواريخ الباليستية والتي سقطت في مناطق مفتوحة، إذ تشير تقارير إلى أن 9 صواريخ إيرانية تمكنت من إصابة قاعدتين إسرائيليتين خلال الهجوم الذي استهدف النقب في جنوب إسرائيل.وتتحدث التقارير عن نجاح إسرائيل في اعتراض 99 في المئة من الصواريخ والمسيرات، في سماء الأردن والعراق بسبب عمليات نفذت الولايات المتحدة معظمها.
على الرغم من الحديث عن خطة أمريكية لبناء تحالف إقليمي ضد إيران إلا أن الخطة الراهنة تسعى لإنشاء مظلة دفاعية إقليمية ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ بالتعاون مع الدول الأوروبية والدول السنية في المنطقة، يعتمد على شبكة من أجهزة الاستشعار المنتشرة في بلدان مختلفة، قرب الحدود الإيرانية. ولم تكن هذه الترتيبات وليدة اللحظة وإنما كانت ثمرة لجهود تواصلت طوال الأشهر الستة الماضية، لبناء نظام للدفاع الإقليمي، أطلق عليه الأمريكيون اسم (تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط).
وتحرص الولايات المتحدة على إبقاء التصعيد عند هذا الحد من خلالها مساعيها لإثناء إسرائيل عن الرد المباشر على الهجوم الإيراني من خلال تأكيدها بأنها لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وستعمل بدلاً من ذلك على تشكيل جبهة دبلوماسية موحدة مع حلفائها في محاولة لمنع التصعيد إلى حرب مفتوحة تجتاح الشرق الأوسط وتورطها، والتنسيق مع إسرائيل ومع دول إقليمية وتعزيز القوات المسلحة الإسرائيلية والمشاركة بشكل موسع في عمليات لتعزيز الردع ضد إيران، ورغم أن الهجوم الإيراني يعتبر في نظر البعض فشلا أمريكيا في ردع إيران، إلا أن واشنطن تسعى لاستخدام التحرك المنسق ضد إيران كرافعة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وزيادة تكلفة التحركات الإيرانية وزيادة الضغط على طهران في المجال النووي. وتدرك واشنطن أن الرد الإيراني سيقف عند هذا الحد لأن هدف طهران هو إعادة التوازن لمعادلة الردع مع إسرائيل للحد من الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف أصولا إيرانية في سوريا. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى تأكيد الولايات المتحدة بأنها تعمل فقط على تشكيل جبهة دبلوماسية في محاولة لمنع التصعيد، خلافاً لتصورات البعض بأنها تسعى لبناء تحالف إقليمي ودولي استعداداً لمواجهة عسكرية مع إيران.
-----------------------------------
بقلم: أشرف راضي